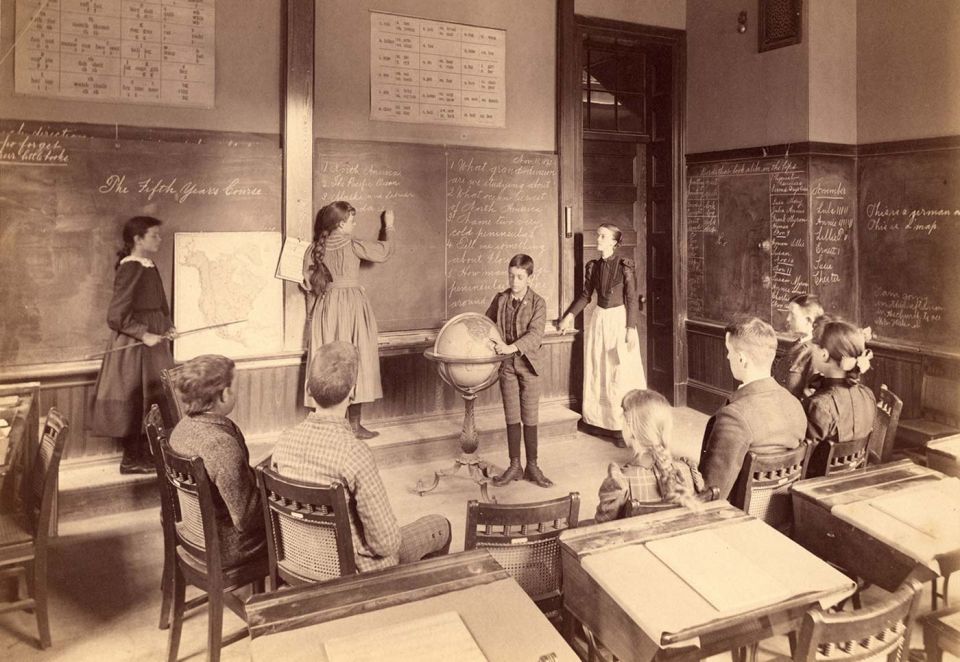د.محمد المعوش
email عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
إن التناقض السياسي، بما هو صراع بين نظامين اجتماعيين وبالتالي بين بنيتين للمجتمع مع كل ما يعنيه ذلك من ميادين الحياة المادية والمعنوية، يشكّل إطاراً يصهر فيه باقي التناقضات، وفي المرحلة الحالية حيث ينطرح على جدول الأعمال تغيير قاعدة المجتمع الطبقي ضمن هذا الصراع، فإن ذلك يعني أنه سيجرّ معه باقي السلسلة. وهذا بالتحديد يعني أن المرحلة الحالية تغلي بكل ما يتضمنه الواقع من تناقضات تحتاج إلى حل، ومن هنا ارتفاع منسوب التوتّر الذي نلمسه في كافة الحقول (الفلسفة والعلوم والفن والعاطفة والأدب...)، وكأن الينابيع المتعددة تلاقت لتشكّل الجدول على حد تعبير لينين، بل إنه النهر الجارف. ولهذا، كل هذه الحقول ستطرح أمامها الإطار الذي سيحكم ممارستها في المرحلة القادمة، ضمنياً أو بشكل صريح. وفي هذه المادة سنحاول أن نقترب من الحقل النفسي الخاص بتعريف الإنسان ما بين «الإنسان الدودة» أو «الإنسان الإبداع»!
من غير المقبول إهمال ظاهرة الأزمة التي يعيشها الوعي الإنساني اليوم، وتحديداً في ظل تصاعد حدة أزمة العالم الحالي. إن زيادة التعقيد الذي حملته العقود الماضية على مستوى تطور العلاقات الرأسمالية لتطال كل مجالات الحياة المادية والمعنوية- الروحيّة، فوصلت ملامح هذا المجتمع التغريبية التي فرّغت المجتمع من إنسانيته إلى نهايتها المنطقية، أي تلك الشروط التي قطعت العلاقة الإبداعية بين الإنسان وعالمه التي هي أساس كونه إنساناً، هذا التعقيد يفرض تعقيداً في عمل هذه الشروط ليس على مستوى الاقتصاد والسياسة، بل على مستوى العقل أيضاً. ويشكّل فهم هذا التعقيد منصة ضرورية لا غنى عنها في سبر قانونية فعل الأزمة التي طالت البنية العقلية لإنسان اليوم. فمآلات هذه الأزمة ترتكز بشكل كبير على التصدي لفعل الأزمة على مستوى العقل من طرف القوى التي تدافع عن بقاء البشرية اليوم. ولا أقل من ذلك!
على وقع المعركة التي تخوضها روسيا في أوكرانيا في وجه النازية كتعبير عن المواجهة العامة مع المنظومة الامبريالية المأزومة ومحاولتها جر العالم أكثر وأكثر نحو جحيم البربرية والوحشية، وما أفرزته الأحداث من انكشاف جوهر النظام العالمي المعادي لكل ما ينادي به من إنسانية وخداع حول اللاأيديولوجيا واللاتسييس، وعلى وقع الموجة العنصرية ضد الروس (حالياً) والصينيين (سابقاً وحالياً) في الغرب بشكل عام، والتي لم توفر الأدب وحتى الحيوان من فاشيتها، يبرز السؤال: هل لروسيا أصدقاء في هذه المعركة؟
كانت هذه المادة منذ عدة أيام مكرّسة لموضوع حركة الفكر ارتباطاً بحدود الزمان والمكان، أي أبعاد النشاط المادي من حيث الفضاء الجغرافي، ومن حيث آفاق هذا النشاط الزمنية نحو المستقبل، وارتباطه بالماضي، أي بمدى كون هذا النشاط منتمياً إلى حركة التاريخ الضرورية. وكانت ستتم الإشارة إلى الحدود المكانيّة والزمانية التي تحاصر النشاط اليوم متمثلة بالكبح الذي يطال عملية التحول السياسي نحو حل القضايا المطروحة والانتقال إلى فضاء علمي جديد. وبالتالي فهي تحاصر العقل، فتلجم نظرته إلى المستقبل، وتصيبه في مقتل عندما تحرمه من شروط وجوده، أي الهدف والدافعية. ولكن أتى الحدث الأوكراني لكي يصبّ في جوهر هذه المادة ويفتح لها أفقها، أي أفق النشاط وبالتالي أفق الزمان والعقل. ولكن هل فهم الجميع الدرس؟
لا بدّ وأنّ الآفاق مغرية للعقل للبحث فيها أكثر من تفاصيل العمليات الحاضرة طالما أننا وضعنا خطوطها العامة، ولكنّ حرارة المِرْجَل الحالي لها سطوع يوازي الظلام المعمَّم، ليس فقط لما تحمله من تكرار وتأكيد وتشديد على ما هي عليه الرأسمالية وعلى مصيرها التاريخي، بل لما تحملها من ظواهر جديدة. وعلى الرغم من أن الكثير من جديد هذه المرحلة تم إنتاج الكثير منه، ولكنّ غناها الحالي يبدو أنه ما زال في بداية تظهيره. وفي هذه المادة سنحاول تكثيف بعض المواد السابقة حول دور الفكرة، وهذه المرة من باب علاقة البنية الفوقية (وتحديداً الوعي بأشكاله المختلفة) بالبنية التحتية (الاقتصادية) لربّما نقدر على تلمّس الشكل التاريخي الحالي لهذه العلاقة وما تعنيه بالنسبة للمستقبل ولفهم بعض العميات الجارية وكيفية التدخل فيها.
مجدداً نحاول أن نظهر وزن الفكرة أو دور الوعي في المرحلة التاريخية الراهنة، وهذه المرة من باب ارتطام الوعي بالواقع، حيث تنخلق اللحظة الواعية بهذا الواقع، ما يعظّم مساحة الفكر في التأثير على العمليات الموضوعية أكثر من أية مرحلة سابقة.
سوف لن نخرج في هذه المادة عن السياق السابق، الذي يحاول التشديد على الحاجة إلى مواجهة تفريغ العالم من العقل الذي هو النتيجة الطبيعية للظروف التي أنتجها نظام الحياة الراهن، مدعوماً بخطة واعية لدى الامبريالية للدفع باتجاه البربرية (في ظروف طبيعية واجتماعية تؤسس للانقراض لاحقاً) خوفاً من أي نتيجة أخرى أكثر إنسانية لا تعريف آخر لها إلا إدارة المجتمع جماعياً لثروته وتحديد مصيره. وهنا نحاول أن نبيّن مجدداً دور الفكرة وارتفاع وزنها لعدة شروط تاريخية، مما يرفع قيمتها السياسية في الصراع القائم.
في المادة الحالية سنحاول إجمال ما سبق وعرضه في مواد سابقة على صفحات قاسيون، مع استغلال المادة المصورة (المحاضَرة) التي تم عرضها على صفحة قاسيون للباحث في العلوم التطبيقية والأساسية في جامعة موسكو للعلوم الإنسانية أندريه فوروسوف تحت عنوان «مستقبل البشرية المهدد من مصالح الطغمة المالية»، هذه المحاضَرة التي يمكن أن تشكل مكاناً تلتقي معه المواد المذكورة، وهناك بالتحديد تتشكّل كمهمّة على جدول الأعمال التي يستكمل العرض الغنيّ الذي قام به فوروسوف.
ذاك الذي يطاله فضاء التجريد كمن مَسَّه روحٌ أو جنّ، ولكن في التجريد تقبع ترنيمة التاريخ الملموس الواضحة. ومن هذه الترنيمات معادلة غرامشي الثاقبة حول المراحل الإنتقالية التي لم يولد فيها الجديد بعد، في حين أن القديم يموت، وفي ذاك الوقت تخرج الوحوش. هكذا هي المراحل الإنتقالية الكبرى في شروط عدم اليقين. عدم اليقين هذا قد يلمسه الأفراد في حدود حياتهم الخاصة المباشرة في مراحلها الإنتقالية المختلفة. ولكن من حسن حظ الترنيمة التاريخية التي نعيشها ببقاء عناصر موروثة من مرحلة الصعود السابقة والتي تمارس ثقلها الضامن على لجم الوحوش، في الحرب تحديداً، وفي الاقتصاد، وفي الثقافة والعلوم أيضاً. وهنا نعرض لمحة قد تكون الأقل بروزاً وأهمية، ولكنها دليل آخر على الترنيمة الحالية، هي قضية «العلم المفتوح».
عرفت مرحلة ما بعد الحداثة بكونها مرحلة التراجع عن العقلانية والتنوير بشكل خاص، ومن ضمنها الفكر العلمي. حيث شهد العالم ردة رجعية وانتعاشاً للأفكار التي جاءت النقلات الثورية البورجوازية (المبكرة) والاشتراكية على السواء لكي تتجاوزها. فعادت بقوة العنصرية والشوفينية والنزعات الانفصالية والتطرّف على كل المستويات والتباعد بين الشعوب والغرق في الشهوانية وتزايد ظواهر الفكر السّحري والأسطوري وتراجع مساحة الفكر العلمي. ولكن مع دخول الأزمة العامة للرأسمالية مرحلة متقدمة نحن أمام مرحلة جديدة تصبغ الوعي بسماتها، هي بالتحديد مرحلة نهاية العقل وليس فقط العقلانية. وسنجد مقدمات ذلك المبكرة في تيارات الفكر العلمي السائد.