رأس المال المالي.. السياسات النقدية والمال العام
واحد من العيوب العديدة للفكر الاقتصادي السائد، هو طابعه الثابت أو لاتاريخيته، من حيث الغياب الفادح لمنظور تاريخي. فرغم التغييرات الهامة في بنية السوق وتشكيله بمرور الزمن، واصل هذا الفكر تمسكه بالنموذج المثالي المجرد للرأسمالية الصناعية التنافسية المنتمي لأزمنة بعيدة.
ترجمة وإعداد: أحمد الرز- سلام الشريف
لا تزال الكثير من الأدبيات الاقتصادية الراهنة، وغالبية «خبراء» الاقتصاد، يحاولون شرح الدورات الأخيرة من الفقاعات والانفجارات المالية، عبر النظريات التقليدية، التي عفا عليها الزمن حول دورات الاقتصاد/ الأعمال. وفقاً لذلك، يواصل صانعو السياسات في رأس هرم البنوك المركزية وإدارات الخزينة، إصدار الوصفات النقدية التي- وبدلاً من تخفيف وتيرة الدورات وشدتها- تميل إلى جعلها أكثر تواتراً واستمراراً.
هذا الافتقار المهم للمنظور الديناميكي الطويل الأمد، أو التاريخي، يفسر لماذا فشل معظم الاقتصاديين التقليديين في فهم أن الأزمة المالية في عام 2008 في الولايات المتحدة، وانتشارها في العديد من بلدان العالم، والركود الاقتصادي العالمي، إنما هي مؤشرات تدل على ما هو أكثر من مجرد «دورة ركود أخرى». إنها تجسد تغييراً هيكلياً، ومرحلة جديدة في التطور الرأسمالي: عصر رأس المال المالي.
هناك عدد من السمات البارزة التي تميز عصر رأس المال المالي عن المراحل السابقة من الرأسمالية، هذه المراحل التي نما فيها رأس المال المالي و/أو ساد، جنباً إلى جنب، مع رأس المال الصناعي. وواحدة من هذه السمات المميزة لهذا العصر، هي التحرر من القيود الضابطة، حيث استطاع رأس المال المالي في تلك المرحلة أن ينمو بشكل مستقل عن رأس المال الصناعي أو المنتج. فقبل صعود التمويل الكبير، وتفكيك القيود الضابطة، نظر إلى دور التمويل بوصفه «تشحيماً غزيراً لعجلات الاقتصاد»، حيث عززت البنوك التجارية مدخرات الناس كودائع مصرفية، وأبقتها كرصيد للشركات الصناعية والتجارية. وفي ظل تلك الظروف- حيث نصت المعايير الضابطة على أنواع وكميات الاستثمارات التي تستطيع المصارف التجارية والوسطاء الماليين الآخرين أن يقوموا بها، شكل رأس المال المالي إلى حدٍ كبير ظلاً لرأس المال الصناعي: لقد نميا أو توسعا بالوتيرة نفسها، إلى هذا الحد أو ذاك.
لكن الأمر ليس كذلك في عصر رأس المال المالي، حيث أصبح شراء صكوك الملكية وبيعها- بدلاً من إنتاج القيم الحقيقية- حقلاً أساسياً للاستثمار، وبات تضخيم أسعار الأصول مصدراً رئيسياً لتحقيق الربح والتوسع (الطفيلي)، ليس عبر إبطاء التدفق التقليدي للمدخرات الوطنية (من خلال النظام المصرفي) نحو استثمارات منتجة في القطاع الحقيقي للاقتصاد فقط، بل عبر عكس اتجاه ذلك التدفق المالي عن الاستثمارات الإنتاجية. فاليوم، هناك تدفق صافي من الأموال يذهب من القطاع الحقيقي إلى المالي.
يقول باري فينغر في كتابه: «حدود تدخل الدولة»: «يدوِّر القطاع المالي العامل بشكل صحي الأرصدة غير المستغلَّة في تكوين رأس المال الإضافي. إلا أن سنوات من إلغاء القيود المالية دعّمت عملية خلق أدوات جديدة أكثر اعتماداً من أي وقت مضى على أساليب ربوية لاكتساب الربح عن طريق تغيير مسار هذه الدينامية، وامتصاص الأرباح تدريجياً من الإنتاج، لتوسيع القطاع المالي على حساب الاستثمار المنتج.. لقد تحولت العلاقة بين القطاعين المالي وغير المالي فعلياً من التكافلية إلى الطفيلية»
المالي يفترس الحقيقي
بحسب روبين هاردينغ، في كتابه: «استثمارات الشركات: الاختلاف الغامض»، فإن إحدى الدلالات الواضحة على هذا الاتجاه المشؤوم لهروب رؤوس الأموال من القطاع الحقيقي إلى المالي، تجلت في التباين الصارخ بين أرباح الشركات واستثمارتها الحقيقية: قبل ثمانينات القرن الماضي، تحرك الإثنان جنباً إلى جنب (كلاهما بحدود 9% من الناتج المحلي الإجمالي). ومنذ ذلك الحين، ازدادت أرباح الشركات إلى نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما انخفض الاستثمار الحقيقي إلى قرابة 4% من الناتج المحلي الإجمالي (فعلى سبيل المثال تبلغ أرباح شركة «فورد» الأميركية المتأتية من استثماراتها في القطاع المالي الربوي أكثر من أرباح إنتاجها الصناعي من السيارات- ملاحظة من المحرر).
هذا يعني بوضوح، أن أجزاءً أكبر وأكبر من أرباح الشركات جرى ضخها من القطاع الحقيقي إلى المالي (غالباً عبر إعادة شراء الأوراق المالية، وعمليات الدمج المشبوهة، والاستيلاءات المفترسة)، وبدأ الاستثمار الحقيقي يتضاءل تبعاً لذلك.
تطويع السياسات.. ورحلات المضاربين
من السمات المميزة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعصر رأس المال المالي، أن آلية تجفيف القطاع الحقيقي من قبل المالي، هي عملية ميسرة عبر السياسات النقدية المصاغة من وكلاء الارستقراطية المالية، القابعين على رأس هرم البنوك المركزية وإدارات الخزينة. فكل إشارة على تراجع السوق، تقابلها حقن سخية من الأموال الرخيصة المتجهة نحو المصارف والمؤسسات المالية الأخرى- بحجة تحفيز الإنتاج والعمالة عبر توسيع الإئتمان منخفض التكلفة لشركات القطاع الحقيقي/ المنتجين. في الواقع، فإن هذه الأموال المعفاة تقريباً من الفائدة، بالكاد تسربت من القطاع المالي إلى الحقيقي، وبدلاً من ذلك، جرى استثمارها في تضخيم أسعار الأصول، أو خلق انتفاخات وانفجارات الأسواق (فقاعات). إذ يتم لاحقاً «معالجة» كل انفجار، عبر حقن جرعات أكبر من المال العام، وبالتالي خلق فقاعة أكبر، التي سترتب بدورها تكاليف اجتماعية أعلى للإنقاذ من الانفجار القادم عبر حقن المزيد من الأموال العامة، وهكذا دواليك.
على هذا النحو، عندما انفجرت ما تسمى بفقاعة ديون العالم الثالث في ثمانينات القرن الماضي، تخلى رأس المال المالي الكبير عن الدول المثقلة بالديون في جنوب القارة الأمريكية ووسطها، وانتقل إلى أسواق جديدة في روسيا، وتركيا، واندونيسيا، وتايلاند، وكوريا الجنوبية، وغيرها في جنوب شرق آسيا، بحثاً عن مشاريع المضاربة الجديدة. وبعد نفخ سلسلة من الفقاعات المالية في هذه الأسواق الجديدة، التي تلتها الانفجارات والأزمات الاقتصادية في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي، حزم المضاربون الماليون الدوليون حقائبهم مرة أخرى، وغادروا على عجل مسرح جرائمهم، وذهبوا للصيد في حقولٍ جديدة من المضاربات.
بناءً على ذلك، اعتبر القطاع التكنولوجي مرشحاً مناسباً لهذا الغرض. فعقب الانفجار الداخلي لفقاعة التقانة، أوما سمي بـ«فقاعة الدوت كوم» في بدايات القرن الحالي، انتقل رأس المال المضارب إلى سوق آخر: سوق الإسكان/ العقارات، الذي انفجرت فقاعته الضخمة بشكل خيالي في عام 2008، مع عواقب وخيمة على 99% من البشر.
لهذا السبب، ليس من قبيل المبالغة القول أنه في عصر رأس المال المالي، تطورت المصارف المركزية كمؤسسات مصممة لتدعيم المصالح المالية القوية بالأموال العامة. إن مقامرة «لا غالب ولا مغلوب» هي تعبير متناقض بطبيعة الحال، إلا أن مصارف «وول ستريت» والمؤسسات المالية الأخرى في الوقت الحاضر هي رابحة في الحالات كلها: فهي تربح في طور تشكل الفقاعات وتوسعها، وتربح كذلك في طور انفجار الفقاعات، إذ يتم تعويضها عن خسائرها عبر أموال الإنقاذ وخطط الإنقاذ المشبوهة الأخرى جميعها (حيث تتم إعادة هيكلة وتمويل رأسمال هذه المؤسسات، عبر خطط التدخل الحكومي الممولة من المال عام- ملاحظة من المحرر). في النهاية، من سيدفع أموال الابتزاز التي استخدمت للبنوك وللمؤسسات المالية الأخرى «غير المسموح لها بالإفلاس نظراً لكبرها»؟ بالطبع، الجواب هو الناس، عبر الإجراءات التقشفية واسعة النطاق.
الديون: بين عصرين
في ظل الرأسمالية الليبرالية في العصر الصناعي التنافسي، فإن دورة طويلة من الانكماش الاقتصادي لن تكنس فقط فرص العمل والإنتاج، بل أيضاً أعباء الديون التي تراكمت خلال دورة التوسع التي سبقت دورة الانكماش. وعلى الرغم من أن دمار الديون الضخمة (إثر تدهور قيمة العملة- ملاحظة من المحرر) غالباً ما تكون مؤلمة، خصوصاً لعمالقة المضاربة المالية، إلا أنه يحدث تأثيراً مفيداً، عبر تخليص المجتمعات/ الاقتصادات من أعباء الديون التي لا تطاق، وتحقيق بداية جديدة، أو يقدم «سجلاً نظيفاً».
على النقيض من ذلك، في عصر رأس المال المالي يتم الدعم المصطنع لتكلفة الديون، عبر تنقيدها- أي تحويلها إلى نقد (من خلال مختلف أنواع السندات والأصول المالية- ملاحظة من المحرر)، وعبر تحميل أعبائها للمجتمع. في الواقع، ونظراً لنفوذ المصالح المالية القوية، فإن عبء الديون الوطنية غالباً ما يتفاقم بسبب خطط الإنقاذ الحكومية السخية لصالح عمالقة المال المفلسين، وبسبب نقل أو تحويل الدين الخاص إلى عام (أزمة الديون العامة في أوروبا مثلاً- ملاحظة من المحرر).
بالتالي، تحولت السياسات النقدية في عصر رأس المال المالي، إلى أداة لإعادة توزيع الدخل و/أو الثروة من الأسفل للأعلى. بالطبع، فإن هذا الأمر يقع على طرف النقيض من السياسات النقدية (والمالية) التقليدية التي سادت في عهد «ديمقراطية الصفقات الاجتماعية»، حيث تم تصميم هذه السياسات للتخفيف من التفاوت في الدخل/ الثروة، لصالح القاعدة الاجتماعية الواسعة. وليس مستغرباً، أنه في البلدان الرأسمالية الأساسية جميعها، بات التفاوت أقل حدة منذ أواخر أربعينيات القرن الماضي إلى أواخر سبعينياته، لكنه أصبح أكثر تفاوتاً على نحو متزايد منذ أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينات.
«إنجازات» العصر المالي
في عصر رأس المال المالي، فإن تحقيق الربح منفصل إلى حد كبير عن الإنتاج الحقيقي والتوظيف، ويأتي معظم هذا الربح من استثمارات المضاربة، أو عبر الانتزاع الطفيلي من باقي قطاعات الاقتصاد. وعلى هذا النحو، فإنه إما لا يوظف أحداً، أو يوظف نسبة مئوية صغيرة جداً من القوى العاملة. ما يعني أن القطاع المالي يولد الدخل/ الأرباح، دون تقاسمها مع الأغلبية الساحقة من القوى العاملة.
وبشكل غير مفاجئ، يمثل الركود المزمن، والارتفاع المتواصل في معدلات البطالة، سمة مميزة أخرى من عصر رأس المال المالي. كما يستولي القطاع المالي، بشكل منهجي، على الجزء الأكبر والأعظم من الفائض الاقتصادي للمجتمع، وبالتالي، يقوض القدرة الإنتاجية لهذا المجتمع.
*إسماعيل حسين زادة: بروفيسور فخري في علم الاقتصاد (جامعة دريك)، له العديد من المؤلفات، منها: «الاقتصاد السياسي للنزعة العسكرية الأمريكية- 2007»، و«التنمية السوفييتية اللارأسمالية: حالة مصر عبد الناصر- 1989».
عن «Counter Punch» بتصرف


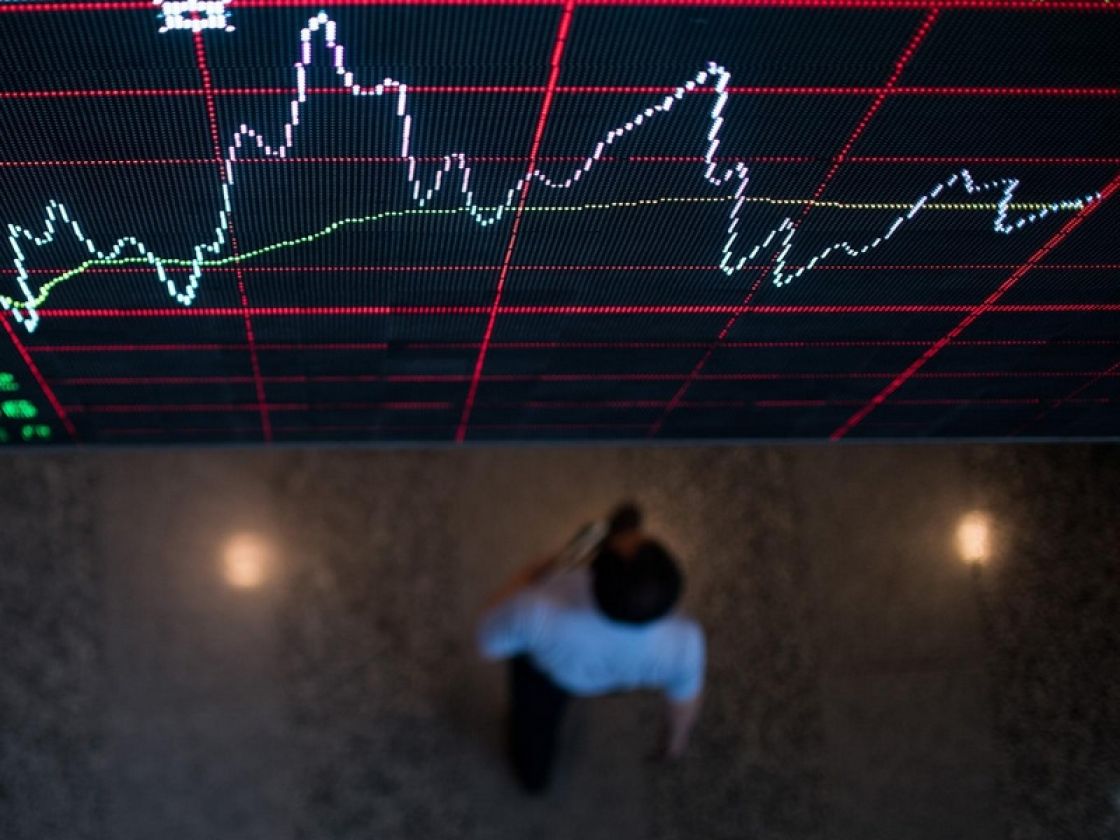
 إسماعيل حسين زاده
إسماعيل حسين زاده