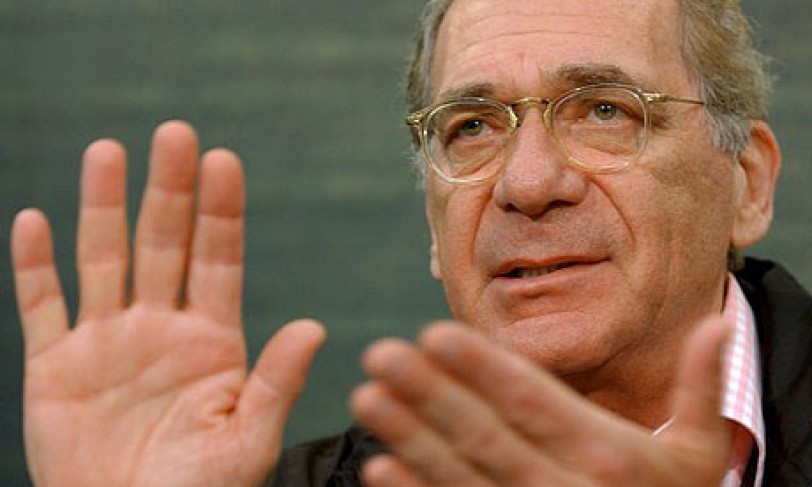«العزبة الملعونة» لسدني بولاك: بين الحب وانهيار الحلم الأميركي
كلهم تقريباً كانوا، في ذلك الحين، في بداياتهم، باستثناء تنيسي ويليامز وناتالي وود. ومن هنا كان يمكن أن يبدو «العزبة الملعونة» فيلماً أولاً، أو يشبه الفيلم الأول لكثر، منهم المخرج سدني بولاك، وكاتب السيناريو فرانسيس فورد كوبولا، والممثل روبرت ردفورد بين آخرين.
لكن الذي حدث كان العكس تماماً: بدا الفيلم ناضجاً وكبيراً. بدا فيلماً يؤسس لنوع سينمائي جديد يمتزج فيه عنف العواطف بالرومنطيقية بالأبعاد الاجتماعية الخطرة. بدا فيلماً على حافة ما كان يمكن للسينما الكبيرة ان تكونه، وستكونه بالفعل خلال العقود التالية. وهذا ما يدفع بعض النقاد والمؤرخين الى اعتبار «العزبة الملعونة» إحدى البدايات الحقيقية لثورة هوليوود الجمالية والأخلاقية التي ستندلع خلال عقد سبعينات القرن العشرين. أما بالنسبة الى «العزبة الملعونة» فكنا لا نزال في العام 1966، يوم لم يكن سدني بولاك، الراحل قبل سنوات قليلة من يومنا هذا، قد حقق سوى فيلم واحد... وخاض تجربته الثانية في الفيلم الذي نحن في صدده. هذا الفيلم أتى اقتباساً كما نعرف لمسرحية من فصل واحد كتبها تنيسي ويليامز من دون أن يزعم انها ستكون من أعماله الكبيرة. فهي ليست، بعد كل شيء، سوى حكاية حب عادية في الجنوب الأميركي على خلفية أوضاع اجتماعية بائسة، من النوع الذي كان في إمكان إيليا كازان، على سبيل المثال، أن يبني من حوله فيلماً متوسط القيمة من أفلامه. ومن النوع الذي كان يمكن فيه لناتالي وود ان تعيد فيه لعب أدوار كان سبق لها ان لعبتها في أفلام لها سابقة، وبعضها من اخراج كازان نفسه. ولكن هنا، وإذ جعل كاتب السيناريو كوبولا والمخرج بولاك، قصة الحب ثانوية الأهمية أمام نتائجها وخلفياتها، كانت النتيجة فيلماً كبيراً.
فيلم «العزبة الملعونة» إذاً، هو بالتأكيد فيلم كبير ذو نسغ شديد الوعي للواقع الأميركي، وتحديداً لواقع الجنوب الأميركي. ولعل أساس الفيلم أتى من قراءة كوبولا لعمق نص تنيسي ويليامز، لروح هذا النص وليس لأحداثه الخارجية، فيما أتت نظرة سدني بولاك لتعطي اللغة البصرية دور المؤشر البرّاني الى ما يعتمل في وجدانية الشخصيات، ولكن خصوصاً في جوّانية الأمكنة. ذلك ان المكان (الجنوب المتنوع) يلعب في هذا الفيلم دوراً أساسياً. وطالما اننا نتحدث هنا عن الجنوب، لا يعود مستغرباً أن ينتمي النص الى تنيسي ويليامز، الذي - على نسق مواطنه ويليام فوكنر - عرف كيف يجعل من مسرحه ونصوصه كلها، تعبيراً عن جنوب أميركي لم يعرف كيف ينسى، أبداً، هزيمته أمام الشمال المتطور والمصنّع، في معركة تحرير العبيد قبل ذلك بقرن وأكثر.
تدور أحداث «العزبة الملعونة» في ولاية الميسيسيبي في ثلاثينات القرن العشرين. وهذه الأحداث تُروى لنا هنا على لسان الصغيرة ويلي التي تحدثنا عن اختها الكبرى آلفا التي عاشت، وفق ويلي، طفولة ومراهقة عاصفتين تحت سيطرة أمهما العنيفة هازيل ستار، التي كانت تدير ذلك النزل العائلي الذي يشكّل محور الأحداث. في ذلك الحين، ودائماً وفق رواية ويلي، كانت آلفا صبية مراهقة فائقة الحسن مقبلة على الحياة مفعمة بالحيوية، لكنها في الوقت نفسه تعيش توقاً غامضاً ودائماً الى البعيد وإلى الحب. صحيح ان كل الشبان والرجال في المنطقة - وهم في معظمهم من عمال ومستخدمي السكك الحديد، كانوا يلاحقون آلفا بحبهم ورغبتهم فيها معبرين في كل لحظة عن إعجاب مبرر لا ينضب. لكن آلفا لم تكن تعير أياً من هؤلاء أي اهتمام. فهي من خلال توقها الى البعيد وتطلعها الى حياة مختلفة في مكان آخر، كانت في أعماق «حديقتها السرية» تنتظر مجيء فارس الأحلام، المميز الاستثنائي الذي سيطل ذات يوم، وفق إيمانها، ليحبها ويكون جديراً بحبها ويأخذها الى البعيد. والحقيقة ان انتظار آلفا لم يطل... إذ ما أن ينقضي بعض الوقت على ازدهار حلمها وتألقه، حتى يصل ذلك الشاب الأنيق اللطيف الساحر، أوين ليغيت (روبرت ردفورد)، الذي ستغرم به ما ان تلتقيه منذ وصوله. والحقيقة ان كل هذا كان يمكنه أن يبدو منطقياً وسهلاً، لولا أن الآتي الغريب، إنما هو هنا ليقوم بمهمة غير مستحبة: فشركة السكك الحديد هي التي أرسلته الى المكان ليتولى ترتيب أمور صرف العمال والمستخدمين من الشركة، على خلفية الكارثة الاقتصادية التي أصابت كل الأعمال والأيام إذ، اننا هنا في خضم ثلاثينات القرن العشرين، خلال السنوات التالية مباشرة لانهيار البورصة الذي رمى عشرات ملايين الأميركيين في الفقر والبطالة - وكان من الطبيعي لأهل المكان أن يحسوا على الفور ان اوين ليغيت هو عدوهم الذي أتى ليحرمهم من لقمة العيش. وإذ أغرمت آلفا بأوين، صارت العداوة مزدوجة. ومن هنا قوطع الرجل وحورب من قبل السكان جميعاً، بمن فيهم هازيل ستار، أم آلفا. غير ان آلفا، لأنها من ناحية أحبت أوين حقاً، ولأنها من ناحية ثانية متمردة في طبيعتها، وكارهة للجو المحلي، عنفت عاطفياً في ارتباطها بأوين وعاشت حبها في تحد سافر مع كل الآخرين، وبالتالي في صراع عنيف مع أمها ومحيطها المباشر. في ذلك الصراع تنتصر الأم بداية، إذ في الوقت الذي يرسل أوين الى نيو أورليانز، بعيداً من المجتمع الذي لفظه، تتمكن الأم من إرغام ابنتها على الاقتران بشخص لم تكن لتبالي به على الإطلاق. وآلفا، بعد رضوخ أول، تستجيب بسرعة الى نداء قلبها وتهرب من النزل الملعون لتنضم الى حبيبها في نيو أورليانز، في اليوم التالي للعرس. وهنا يتدخل القدر على شكل مرض صدري يصيب آلفا ما إن حصلت على قسط من السعادة المزدوجة: الحب والانتقال الى المكان الآخر... الى البعيد. وهذا المرض العنيف سرعان ما يقضي على الصبية، فيما ينتج من ذلك كله ان أسرتها تتفرق وينتهي الأمر، بينما تختتم ويلي الحكاية.
إذاً، هذا الموضوع الذي يشبه اية حكاية حب عادية تنتهي بموت أحد طرفيها، تحوّل تحت يد الذين اشتغلوا عليه الى عمل اجتماعي أخلاقي مهم، كما انه صار بالنسبة اليهم مدخلاً الى عالم السينما الكبيرة كما أشرنا، خصوصاً ان الفيلم حفل بالمشاهد الكبيرة التي تكشف نظرة الفنانين الكبار الى الحلم الأميركي وتعليقهم على انهيار حصتهم منه (في هذا المجال يفيد التذكير بالمشهد الرائع حين تتحدث آلفا عن حلمها الربيعي وهي جالسة وسط عربة قطار خربة صدئة). واللافت ان تنيسي ويليامز، الذي وقف مسانداً الفيلم منذ البداية، قال دائماً انه يعتبره الأنجح بين الأفلام التي اقتبست من أعماله. وهو قول من الصعب أن نوافقه عليه، ويوافقه عليه من تتبع مسيرة علاقته بالسينما، إذ نعرف ان ثمة أعمالاً سينمائية كبيرة جداً عرفت كيف تقتبس نصوصه وتنسى أصولها المسرحية، وهي أعمال حملت تواقيع جوزف مانكفتش وإيليا كازان وجوزف لوزاي، وريتشارد بروكس بين آخرين.
مهما يكن من أمر، يمكننا أن نؤكد هنا ان «العزبة الملعونة» عرف كيف يرفع مخرجه سدني بولاك، الذي كان يومها في الحادية والثلاثين من عمره، الى صفوف أولئك الأساتذة الكبار. فهو الذي تأسس أصلاً في العمل المسرحي والتلفزيوني، حقق من بعد «العزبة الملعونة»، سلسلة كبيرة من أفلام ربما تكون أساليبها كلاسيكية ولكن من الواضح انها واكبت بقوة، تلك الثورة الهوليوودية التي يصعب، على أية حال، ربطه بها عضوياً، بل يمكن ان يقال انه عاش وعمل حتى سنواته الأخيرة، متأرجحاً بينها وبين كلاسيكية خاصة به. وبولاك، الذي ظهر ممثلاً بين الحين والآخر (تحت إخراج وودي آلن أو تسانلي كوبريك)، حقق أعمالاً عرف كل منها كيف يكون علامة في مجاله، من «الحياة التي عشناها» (1973) الى «الفارس الكهربائي» و «خارج أفريقيا» و «أيام الكوندور الثالثة»، ثم خصوصاً «جيريميا جونسون» الفيلم الذي لعبه ردفورد أيضاً والذي يعتبر من العلامات الهوليوودية الأساسية في مجال التصدي للتاريخ الأميركي بعيداً من الظلم الذي ألحقته السينما بالهنود الحمر، والظلم الذي ألحقه التاريخ بالطبيعة نفسها وسيرتها.