لماذا تنقلب الوصايا على شعرائها ...؟
دائما ما يهتم الشعراء في خريفهم الأخير، أو فيما تبقى لهم بوصاياهم التي لها شكل الوصية، لكنها تحمل الكثير من المراد قوله قبل موت مفاجئ.
فكثيرا ما تكون تبريراً لمواقف قد يفندها الزمن أو فندها فعلاً أو لرأي سياسي لا يود العلن، أو أملاً بحياة أرحب يريدونها لمن بعدهم ..لم يستطيعوا هم أن يوجدوها .. وربما تكون القصيدة الوصية استشرافاً لموت آخر، قد يتبع موت الشاعر الجسد كموت ذكراه الشعرية، فوصايا الشاعر محمود درويش كانت لعناته التي ربما ترافق ذكراه للأبد، فهو الذي خاف طيلة حياته من تبادل الأدوار وانقلاب التاريخ على حقائقه، ودرويش الذي حذر من التسليع و من الثقافة النفطية الاستهلاكية ومن أن تصبح نصوصه سلاحاً للفتاوى أو الندب، أصبح كلامه قاتل المعنى، بعدما بدأ شعره يقتطع على صفحات التواصل الاجتماعي والتلفاز، كأقوال أي سياسي مهزوم أو دكتاتور مسن، حينما لا تظهر كلماته إلا مشبعة بالتقريرية والخطابية والإرشادية، محمود الذي حملت ظهور نصوصه أرضاً بكل أحيائها وبياراتها وعرائشها وحبال غسيلها إلى موعدها مع الأزل، يغدو اليوم وجبة ترفيهية تطل كل مساء وصباح، و كافيتريا متنقلة للعشاق العجولين.
لا يدري أولئك أي كون يسكن القصائد، كل القصائد، فالقصائد والنصوص مشاريع وخرائط معرفية وشبكات دلالية، وصيرورتها تجربة مع التاريخ والحدث والواقع وعلاقة مع العالم، لذلك عند القطع والاقتطاع إلى شذرات وومضات مجبولة مع بعضها، تمسي تخريباً و انتقاماً وإبعاداً لزمنها وصوتها الباطني .. وقتلاً للشعر ولدرويش،لأن درويش لم يكتب قصيدة الومضة (القصيرة جداً) لضيقها على صرخته التي لم تحتويها سرديّاته ونصوصه الطويلة حتى موته، لقد نظر درويش دائما إلى القصيدة على أنها فعل تغير ونهوض تستمد طاقتها من تتابعها، حيث تؤسس بازديادها، الوجود والمعنى، وهذا ما قصدناه بجملة (حتى موته)، لذلك لم يطمح يوماً ليصبح نبياً زردشتياً أو نيتشوياً يقول ما يشبه حكمة أبدية مكتملة، أو شاعراً للومضات العجولة التي تردد عن الاصطدام مع الوجود.
أعرف أن الكل يملك ألفته وحكايته مع نصوص ذلك الكنعاني، وللكل الحق في مشاركة تركة درويش، ولكن الكل أيضاً مدعوون لنزال درويش وللحفر في خطابه، وليس الامتطاء والبعثرة فقط، أعرف أني وربما كثيرون غيري لا نتفق مع المرامي السياسية لقصائد درويش منذ مطلع الثمانينيّات، وأخص استراتيجية الخيبة البطيء، واليأس التصاعدي، وسيطرة ألعاب اللغة، لاستعار الذات أو لتحريرها، لكن شعرية درويش و عوالم نصوصه المنعتقة عن أفول لذة القراءة ليست بالداء الهيِّن على العلاج، خاصة بعدما صارت وشماً في أغاني الذات مع الفن في ذهنية الأجيال التي قرأته، فمازلت أتذكر نصوصه في المناهج الدراسية السورية منذ المراحل المبكرة عندما كانت تقف على عتبات آذار أو نيسان صانعة مدى لا يتعب، ومجددة خيال الحكاية، لقد أمضى محمودا جيله يمتدح الغرباء، والعابرين غرباء الأرض واللسان والوجود والمفاهيم والمصير، والعابرين جحيمهم وجحيم الآخرين.. عابرين الموت الدائم في النص والواقع، فهل هو آخرهم؟ عابراً غريباً عن قصائده وكلماته التي أضحت في الشابكة، وفي الأسواق منتجاً مسجلاً، و قد عادت و سكنت في لبِّ هواجسه، أرادوه ميتاً وللذي أرادوه له قد ذهب..وهو الذي أهدى أصدقاءه من الشعراء والكتاب عيون شعره. بموته الجديد الآن يموت القارئ الأخير لأصدقائه – للشعراء - لأن من كان ليقرأه بحذر سيفتح نوافذ على شعرائه ورفاقه وعلى تزامنيته، لكن قراءه الجدد المشغولين بتشيئه، لن يهتدوا إلى ممرات الكلام بينه وبين شعراء غيره غذوه وغذوا الواقع الذي أنتج فيه_ إلى متى يا نزيف القيم ؟!!_ حذر من حبه ومن حب قضيته ومن حذر الكتابة عنها خوفا من أن تصبح ظاهرة صوتية، تنهبها الآنية، ومن ثم الشتات لتنتهي قضية نصية فقط تعيش فوق واقعها، لكنّ بدقة التحذير وقع المحذر، فهل زرع التقاعد الخارج نصي – كالتقاعد السياسي عن الظواهر المعرفية والاجتماعية والتاريخية – الذي شوهد في شعره موت التأويلات.. إلا عن اسمه وحضوره بعدما طالت حياديته قبل موته.. لمّا بكر الانسحاب وجعلهم يألفونه كلاماً عابراً للقضايا وللإشكالات بمطموراتها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، أم أن تكثيفه اليوم لعبة الإهلاك والاستهلاك نفسها التي لا يشبعها إلا وجبات المعنى.


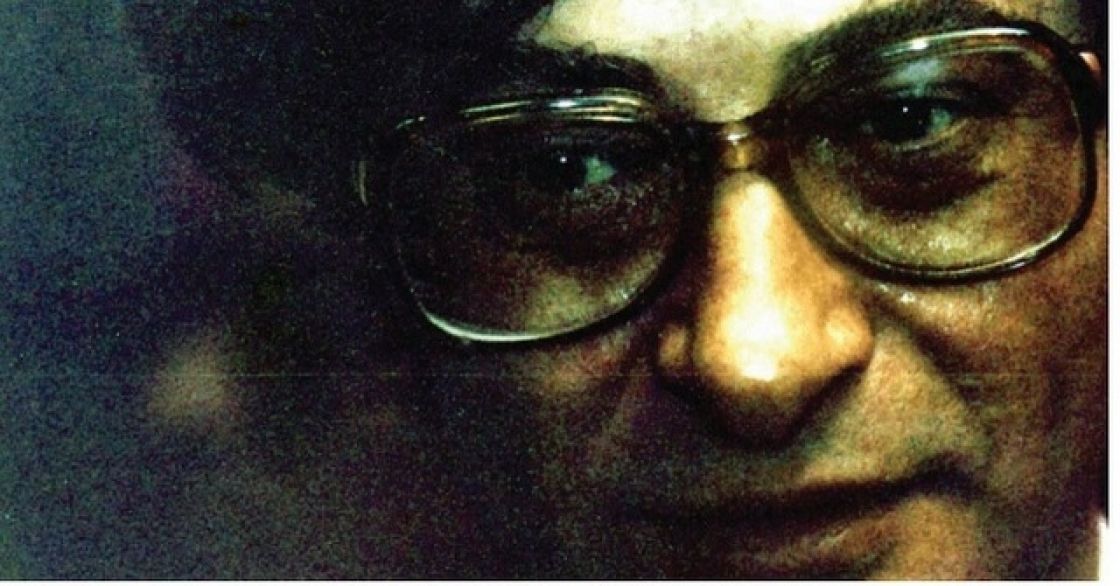
 النديم بو ترابة
النديم بو ترابة