نفسية الخُسران
كنت أظنني وحدي في هذا الأمر. لذا كنت غاضبا على نفسي كل الغضب. غير أنني أخذت اكتشف أنه مرضي مرض وطني، إذا صحت العبارة. فقد قال لي ابن جاري (مجد) ذو الثامنة من عمره، حين جلسنا لنشاهد مباراة كرة قدم على شاشة التلفزيون: أنا مع الفريق الضعيف
أنا دائما مع الضعيف. وفاجأني قوله بقوة. لكنني قلت له معاندا: أما أنا فمع القوي. وكنت، في الحقيقة، أعاند نفسي ومشاعرها التي طالما كرهتها. فالذي يملك الرقم صفر كان صديقي دائما. لذا كنت منشقا دائما. فكلما حصل انشقاق في حزب ما كنت انشق مع المنشقين الخاسرين، مقنعا نفسي أنني مع الأنظف والأكثر مبدئية. غير أنني في الحقيقة كنت أكذب على نفسي، فأنا مع الخاسر لا مع الأنظف، سواء تعلق الأمر بالسياسة أم بالرياضة. لكن لنفترض ان المهزوم تمكن، بوسيلة ما، من التفوق فما الذي سيحصل لي؟ كن على ثقة أنني سأغير موقفي وسأبدأ، تدريجيا، بتأييد الطرف الآخر. هكذا أنا، الهزيمة أقرب إلي من الانتصار. وشيطان تعرفه خير من ملاك لا تعرفه. وأنا لا أعرف الانتصار.
لكن المشكلة أنني بدأت أدرك ان مشكلتي هي مشكلة عامة عند الفلسطينيين. فهم وقفوا تاريخيا مع الطرف الخاسر. حصل ذلك في الحرب العالمية الثانية وفي الحرب الباردة، وفي حرب الخليج. وأكاد أثق بأنهم سيقفون مع الطرف الخاسر في حرب جزيرة حنيش في فم باب المندب.
إنها بنية نفسية شاملة. وما أنا إلا من غزية ان غوت غويت. أما الشاعر محمود درويش فقد قدم الصياغة الفلسطينية الناجزة لهذه البنية في مقابلة له مع مجلة «مشارف». يقول: «أنا منحاز تماما للخاسرين. ويضيف: أختار أن أكون طرواديا، لأنني أحب ان أبقى ضحية». إنها صياغة تامة وناجزة. لكنها في الواقع، صياغة مرعبة، فالرغبة في الخسارة أوصلتنا، هنا، إلى الرغبة في لعب دور الضحية. نحن نحب، إذاً، أن نكون ضحايا. وثمة خطوة صغيرة جدا تفصل بين من يحب دور الضحية ويتقنه وبين الإعجاب بالقاتل. فإذا كنا نرغب في أن نكون ضحايا، فمن المنطقي ان نصل، بخطوة صغيرة، الى الإعجاب بقاتلنا.
وقد زادني هذا الاستنتاج غضبا على نفسي وعلى مشاعري. فأنا لا أريد أن أكون مع الخاسرين، ولا أريد ان أكون ضحية. لهذا عندما بدأت أنا وابنة صديقي (تالا) ذات الرابعة من عمرها في مشاهدة فيلم كرتوني عن الأشرار والأخيار، قلت لها: أنا شرير، أنا أحب الأشرار. فقالت هي بلهجة المذكر: أنا شرير. أنا بحب الأشرار كمان. ثم زأرنا معا: نحن أشرار.. نحن شريرون.
لكنني في الطريق إلى منزلي فكرت أننا، أنا وتالا، لم نفعل سوى قطع الخطوة الصغيرة التي تحدثت عنها، والتي نقلتنا من لعب دور الضحية، إلى التماهي مع القاتل، الشرير.
وتذكرت لحظتها أنني رأيت قبل سنوات، مشهدا كانت فيه طفلة فلسطينية في الرابعة تمسك عصا تضرب الأرض بها وتصرخ في الأطفال الذين معها: أنا إسرائيل.. أنا إسرائيل. وكان ذلك في عز الانتفاضة (الأولى)، أيام تكسير عظام الأيدي والأرجل.
وبدا لي أن المسألة أعوص مما قدرت في البداية، فلقد دخلت دائرة شريرة، ولم أعد قادرا على الإفلات منها. أنا مربوط بعدوي بسلاسل من جهنم. فإما أن أكون صورته في المرآة، وإما أن أكون ضحيته.


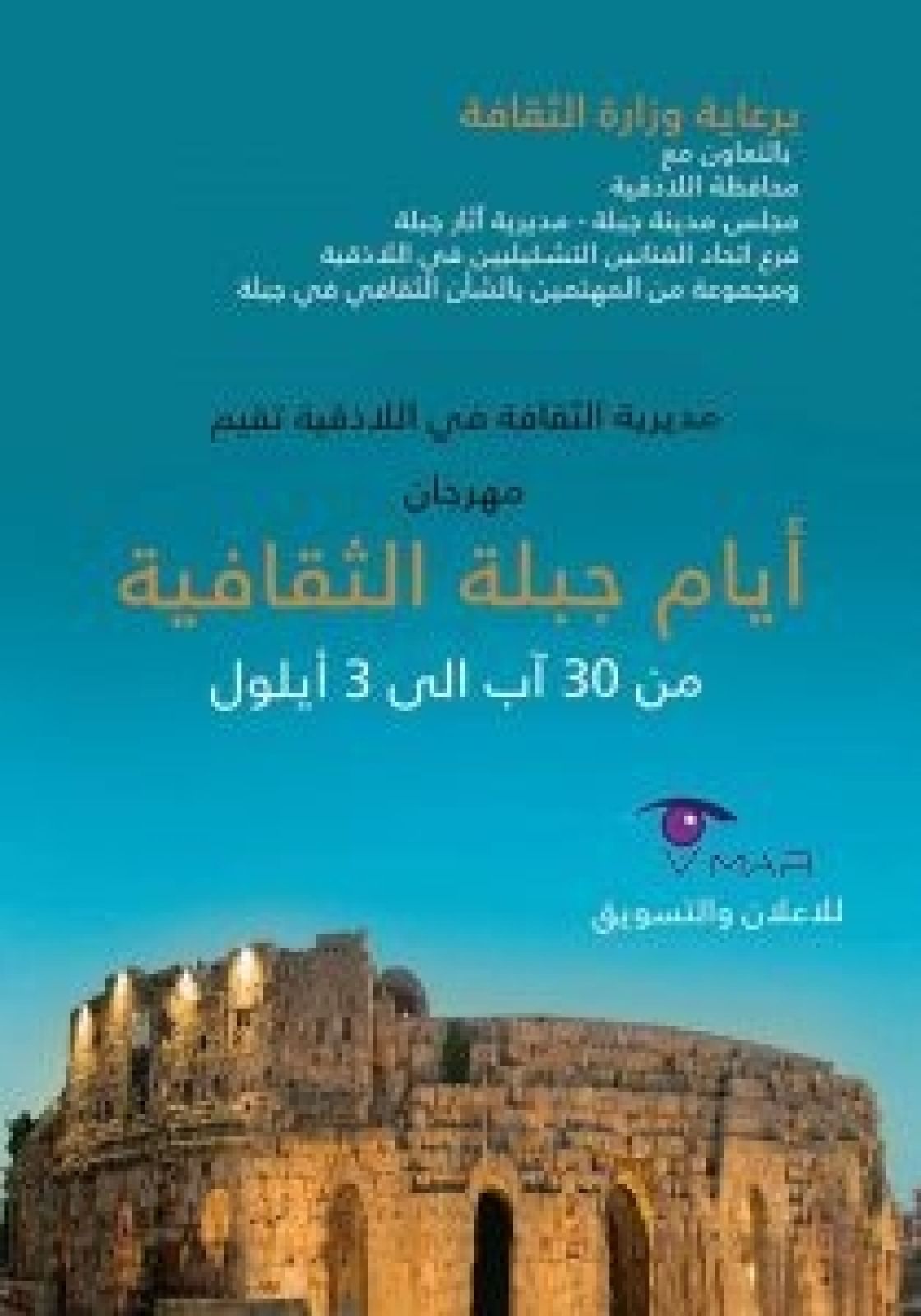
 زكريا محمد
زكريا محمد