تجربة الأدب الفلسطيني الحديث (1 من 2)
إن أدب التجربة الفلسطينية يملك خصوصية تميزه عن جميع التجارب الأدبية الإنسانية، لأنه أبعد بكثير من أدب الأنا الجمعية في سعيها إلى الحرية لتقوية ذاتها في مواجهة الآخر العدواني
ولم يكتف الأدب الفلسطيني فترة ما قبل النكبة بالحالات الذهنية والمشاعر بل استشرف مخاطر النكبة، وحذر من ويلاتها قبل سنوات من وقوعها، ورصد خيوط المؤامرة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني، منذ صدور وعد بلفور، وفرض الانتداب البريطاني على فلسطين، والدعم البريطاني للصهاينة في التمهيد لإقامة الكيان الصهيوني، وكذلك تعرية الزعامات العربية والفلسطينية المتحالفة مع الإنجليز، ومناصرة الزعامات الوطنية المحاربة للإنجليز والصهاينة.
وبعد عام واحد من الانتداب وقف أحد اللوردات في مجلس اللوردات البريطاني، أعلن أن وعد بلفور مشحون بالديناميت، ووصف الظلم الذي يتعرض له عرب فلسطين بأنه «ظلم لا سابقة له في التاريخ».
إلا أن المخطط بدأ ولم ينته، وبعد عام من تولي «صمويل» ثار عرب إحدى المناطق الجبلية بفلسطين «في25 يونيو1921»، فذهب إليهم المندوب السامي في حراسة السيارات المسلحة، ليستقبله عرب المنطقة رافعين الأحذية القديمة على عصي مرددين الهتافات المعادية له ولليهود. كما نشر مؤخراً أن أحد المصورين الصحفيين الأجانب اختفى في ظروف غامضة. ربما يعتبر الخبر عادياً لولا أن ذاك الصحفي هو الذي ارتكب الخطأ التاريخي والتقط الصورة الشهيرة، والتي باتت رمزا للانتفاضة الفلسطينية. صورة ذلك الصبي النحيف القصير «من ظهره» ثابتا على الأرض، رافعا يده اليمنى إلى أعلى رافعا الحجر في مواجهة الآلية الحربية المتقدمة نحوه.
يبدو أنه منذ ذاك اليوم البعيد، عام 1921م لم تسقط الأحذية القديمة، وإن استبدلت بحجر. وبدلا من الرجال والشباب، تولى المهمة الصبية والأطفال! ومع ذلك يقول د.محمد عبدالله الجعيدي في تقديمه للببليوجرافي الهام عن الأدب الفلسطيني «مصادر الأدب الفلسطيني الحديث»: «وللتدليل على الإهمال الذي لاقاه الأدب الفلسطيني، لأسباب غير موضوعية، تكفى الإشارة إلى أنه حتى عام 1967م، لم يعرف على صعيد البحث الجامعي غير أطروحتين جامعيتين. الأولى بعنوان: «حياة الأدب الفلسطيني الحديث من النهضة حتى النكبة» للباحث عبد الرحمن ياغي «جامعة القاهرة». والثانية بعنوان: «موقف الشعر العربي الحديث عن محنة فلسطين من2-11-1917 إلى 31-12-1955» للباحث كامل السوافيري « جامعة القاهرة».
إن أول مطبعة دخلت فلسطين عام1830م بمعرفة الإرساليات الأجنبية، وأول مطبعة وطنية أحضرها «باسيلا الجدع» إلى حيفا عام1908م.. وظهرت بعض المطبوعات الأدبية وشبه الأدبية. فكانت أول مجلة قصصية شهرية على يد «بندلي بياس مشحور» عام1924م، وتعددت المجلات التقليدية والثقافية. وطبعت الكتب وخصوصا كتب الشعر، حتى أن مؤسسة ثقافية مثل «لجنة الثقافة العربية» بالقدس نظمت أول معرض للكتاب الفلسطيني عام1946م.
ومن أهم الشعراء الذين وثقوا لتلك المرحلة شاعران هما عبد الرحيم محمود ( 1913-1948) وعبد الكريم الكرمي (أبو سلمى ) (1911-1984).. حيث لم يكونا من الشعراء الكبار على مستوى البناء الفني للقصيدة ولكن شهرتهما جاءت من قوة طرح الموضوع السياسي الحاضر بقوة على الساحة الفلسطينية في تلك الفترة، والتنبيه للمخاطر التي تحيط بفلسطين الأرض والإنسان.
أما توفيق صايغ (1924 - 1973) كان أحد الذين خرجوا عن السياق السياسي بشعره عن الشكل المألوف في تلك الفترة، وفدوى طوقان التي صدمت الواقع السياسي في بداية الأربعينيات بما في شعرها من حربٍ ضد الموروث الاجتماعي. أما الفن القصصي قبل 48 فقد كان في مراحله التجريبية، وقد كان الفن القصصي العربي عموماً يفتقر إلى التجربة التراكمية، حيث لم ينجح الكتاب حتى تلك الفترة في إرساء قواعد لهذا النوع من الأدب، ورغم ذلك فقد عرفت أسماء مثل خليل بيدس (1875-1949) وأحمد شاكر الكرمي (1894-1927) وجميل البحري (توفي شاباً 1930) حيث أسس كل منهم مجلة أدبية خاصة وأشرف على تحريرها بنفسه، وكانت معظم ما تنشره تلك المجلات عبارة عن قصص قصيرة مترجمة من الأدب الروسي أو الانكليزي.
وتعود أول رواية فلسطينية إلى خليل بيدس تحت اسم «الوريث»، وظهرت في القدس عام 1920، ونشر أيضاً مجموعة قصصية بعنوان «آفاق الفكر» عام 1924 في القاهرة. والرواية الثانية في الأهمية هي رواية اسحق موسى الحسيني «مذكرات دجاجة» 1943 وقد كتب لها المقدمة د.طه حسين، وقد طبعت عدة مرات لما حصلت عليه من شهرة آنذاك في العالم العربي. وكانت معظم الأعمال القصصية في ذلك الوقت ذات منحى تعليمي وإرشادي.
فلما كانت نكبة 1948م، فُقِدَ أغلب المنجز المطبوع ضمن ما فقدته الثقافة المحفوظة بين دفتي الكتب، بعد أن فقد الفلسطيني الأرض والبيت، ماذا عساه أن يحمل معه إلى الخيمة، وهو ما عبر عنه الكاتب عيسى الناعوري في كتابه «أدب المهجر» سواء بالنسبة له شخصيا أو لغيره من الأدباء الفلسطينيين في تلك الفترة، لا أحد يحمل كتابا. ومع ذلك فقد بدأت بعض المطابع والمؤسسات الثقافية في تبني الأدب الفلسطيني «بعد النكبة»، إلا أنه لم يكن بالقدر الوافر والواجب الملائم للقضية وضرورة التعبير عنها، بسبب القهر السياسي والوضع الجديد الذي أصبحت عليه البلاد.
وأبرزت بعض الدراسات ملامح الإبداع الفلسطيني الحديث على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى وقد شهدت ثلاثة اتجاهات: الاتجاه الإحيائي الذي ينتمي إلى ملامح الأدب العربي عموماً والانتماء إليه، وبرز جليا في الشعر وليس في الرواية- أما الاتجاه الثاني فهو الاتجاه الرومانسي، وربما هروبا من الواقع القاسي المعاش ورفضا له، لكن دون أن ينسى أصحابه الوطن، فكانت الروايات: «صراخ في ليل طويل/ جبرا إبراهيم جبرا»، و«وحدي مع الأيام/ عبد الحميد ياسين»، و«عابرو السبيل/ نجوى قعوار فرح». أما الاتجاه الثالث، وقد تبلورت الأحداث وأنتجت أفكارها وأناسها، فكان الاتجاه الواقعي النقدي. لقد اشتعلت الثورة هنا وهناك، واستشهد الأدباء قبل غيرهم. يرصد هنا أن أول قصيدة كتبت على الأوزان الحرة في فلسطين كتبها «محمد إسعاف النشاشيبي» في أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي وكانت مرثية في الشاعر أحمد شوقي، كما شهدت تلك الفترة أول قصيدة نثرية للشاعر حسن البحيري بعنوان «أحلام البحيرة»، حيث كانت فترة فوران وتمرد على الواقع المعاش هناك والأحداث الدموية بداية من «ثورة البراق»، ثم الثلاثاء الحمراء حيث أعدم الشيخ فرحان السعدي، واستشهاد الشيخ عز الدين القسام، كما أجهض الإضراب العام بكل شراسة وقسوة المستعمر.
كما أن تلك المرحلة السابقة على عام 1948م ، ومع اقتراب التاريخ المشؤوم، بدت إرهاصات التوجس من «النكبة»، وقد عبر عنها الشعراء أسرع وأوضح من الروائيين. وهذه الروايات هي: «البطلة/ خليل بيدس»، «الظمأ/ محمود سيف الدين الإيراني»، و «أي السبيلين/ نجوى قعوار»، و«فلسطين تستغيث/ عيسى العيسى»، ثم «مذكرات دجاجة/ اسحق موسى الحسيني»، وتعد الأخيرة هي أول رواية ذات تقنية تتجاوز ما سبقها في كل إنتاج الرواية الفلسطينية وقد نشرت عام 1943م.


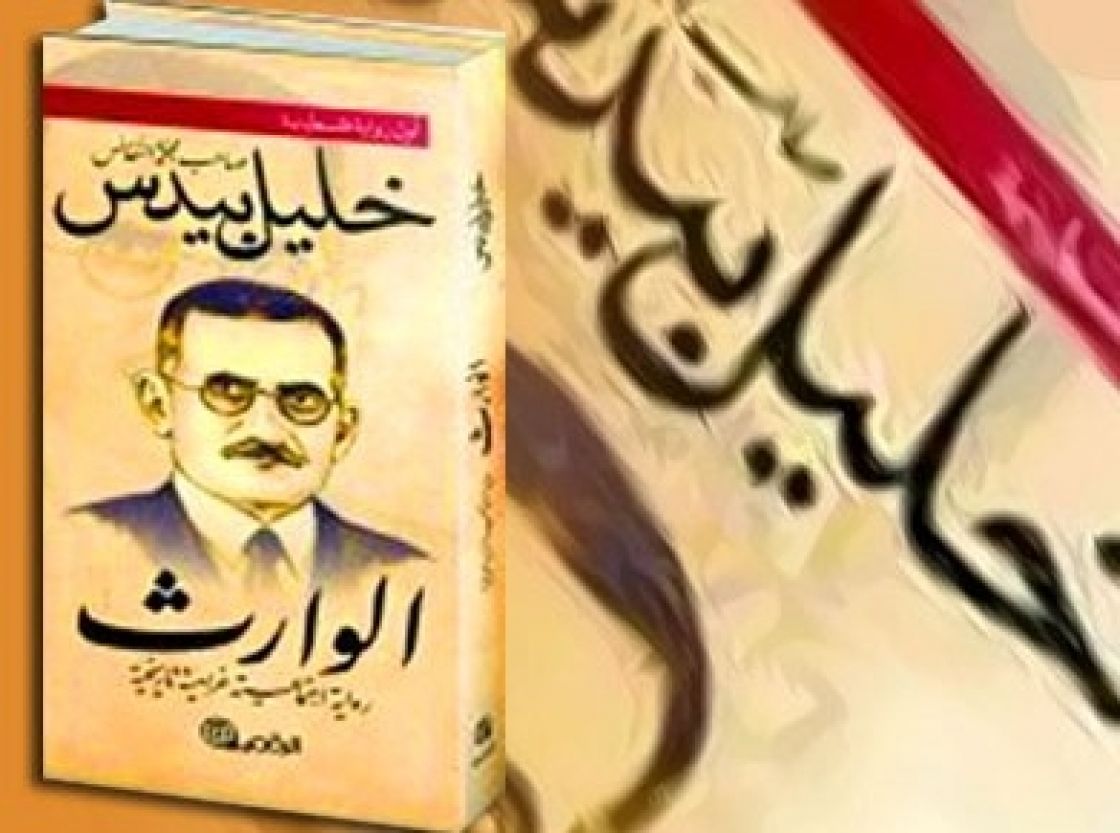
 حسام زيدان
حسام زيدان